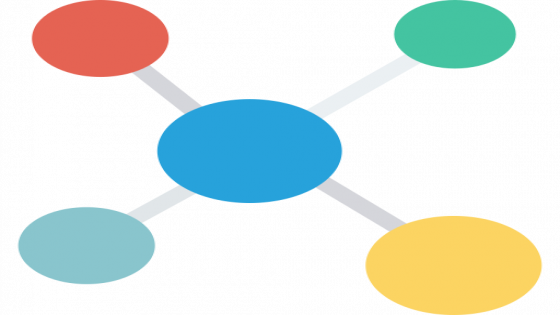عبد غزال
تقديم:
إن مرحلة الشباب هي أخصب مراحل العمر، وهي مرحلة العطاء، والشباب في أي مجتمع من المجتمعات عنصر حيوي في جميع ميادين العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، وهم المحرك الرئيس الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمعات، ودوماً يشكلون المعادلة الرئيسية في أي ثورة إصلاحية، وأداة فعالة مهمة من أدوات التطور الحضاري للمجتمع. ويُعتبر ضمان حصول الشباب على فرص كاملة وعادلة في شتى جوانب الحياة؛ أمر أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فعندما يزدهرون، تزدهر كذلك أسرهم ومجتمعاتهم، وفي مقابل ما سبق تساهم جودة ونوعية التعليم التي تسبق مرحلة الشباب؛ في تحقيق نتائج محسومة على نموهم وإنتاجيتهم دورهم في التغيير الاجتماعي، وتصبح مجتمعاتهم أكثر استقرارًا، وتنمية أكثر استدامة. باختصار، تمكين الشباب في إطار تعليم حر ونقدي؛ ضروري لتحقيق قدراتهم وقدرات أسرهم ومجتمعاتهم.
عند متابعة الإحصائيات الرسمية الفلسطينية؛ نجد أن نسبة الشباب من عمر (18-29 سنة) في فلسطين نحو 23% من إجمالي السكان (1.13 مليون)، وبلغت نسبة الجنس بين الشباب بواقع 105 شاب لكل 100 شابة، علما بان تقديرات عدد السكان في فلسطين منتصف العام 2019 تشير إلى أن إجمالي عدد السكان بلغ نحو 4.98 مليون، غير أنّ نسبة تمثيله في مواقع صنع القرار لا تتجاوز 1%.. [1]
تدرس هذه الورقة البحث عن واقع وظروف التنشئة الاجتماعية التي تلعب دوراً في مشاركة الشباب في الحركات /الحراكات الاجتماعية، بالنظر إلى كون مناهج التعليم والتربية تلعب دور رئيس في تصورات ومعتقدات الشباب حول أدوارهم في الحركات الاجتماعية/الحراكات الاجتماعية، وندرج أدناه أهم الأهداف: –
- كيف يجري تثقيف الشباب ومعرفة أدوارهم في الحياة العامة
- كيف تعمل المناهج على تكوين مواقف واتجاهات الشباب نحو الحركات/الحراكات الاجتماعية
- إفرازات المناهج على أنماط مشاركة الشباب في الحركات/الحراكات الاجتماعية
سؤال التنشئة وتطور الدور الاجتماعي والمنظور الشخصي للشباب (من الأهل إلى الشلة)
يتهيأ الشباب في المرحلة التي تسبق مرحلة الشباب ويطلق عليها مرحلة المراهقة إلى تفتح التفكير والوعي بالواقع الاجتماعي والانتماء الطبقي وخصائص الطبقات، واتخاذ المواقف، ووعي الانتماء إلى طبقة اجتماعية اقتصادية وإلى هوية ثقافية، وبحسب عالم النفس أريك أريكسون تعود المواقف الثقافية للشباب إلى عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال، وتساهم في التعامل مع المشاكل والتحديات التي تواجهه في كل مرحلة وتؤثر فيها. وهنا يتفق أريكسون مع عالم التحليل النفسي سيجموند فرويد في أن الطبيعة الفطرية تحدد سلسلة المراحل للنمو، وتضع الحدود التي تحكم عملية التنشئة، لكنه أختلف مع فرويد في تركيزه على أهمية الثقافة في بناء الشخصية، وكذلك اختلف معه في نقطة جوهرية تتعلق بدوافع السلوك الإنساني فهي من وجهة نظر فرويد متمثلة في الغرائز البيولوجية مثل غريزة الحياة وغريزة العدوان، لكن من وجهة نظر إريكسون فهي تتمثل في التفاعلات الاجتماعية المتبادلة للإنسان في عالم الخبرة الاجتماعية[2]
في مرحلة الشباب يتجه الشباب للتفكير بالاتجاهات السياسية، والانتماءات السياسية، والمنظمات والهيئات السياسية، والانخراط في الانتماءات الوطنية والثقافية، وفي هذه المرحلة أيضاً تتعزز لديهم ميول التعصب والتطرف، أو التفهم والتعاون. فتظهر عليهم علامات اتخاذ موقف من القضايا السياسية والاجتماعية وبداية فهم التاريخ وأثره على الوقائع والأحداث، وتتكشف نوعية قضايا الحقوق الفردية وتناقض المصالح بالنسبة لهم، وتتطور لديهم مفاهيم الحرية والعدالة والمبادئ السياسية والعقائد الحزبية. فهم وإن لم ينضموا رسمياً إلى تنظيمات وحركات اجتماعية فإن ميلهم دوماً إلى المثالية السياسية والاجتماعية.
وفي القضايا المصيرية التي تخص الوطن مثال قضايا العدوان والاجتياحات، التي تواكب بروز حركات التحرر والثورة والانتفاض على الاستقلال، والاستعمار، تبرز مثالية الشباب، ويبدون استعدادية للتضحية، وقد يقدمون إذا توفرت الظروف وكان هناك انتماء قوي إلى الانخراط في التحركات والإقدام على المخاطرات من أجل القضية السامية والدفاع عنها، وهنا تتجلى روح التضحية والعطاء بأحلى صورها في حالة من ذوبان الشاب في الجماعة أو القضة وتناسي الذات والتركيز حولها. ويتخذ البحث عن الذات هنا دلالة أخرى متحولاً من الفردية والانغماس في الذات إلى الجماعة والاندماج في القضايا الجمعية ومعاركها التي تعطي الذات دلالة جماعية، وتأخذ الهوية الذاتية معنى مثالياً يتجاوز الكيان الفردي.
في مرحلة الشباب ينفتح ويتطور تفكير الشباب المجرد، والتفكير في مجال التساؤلات الأخلاقية ومناقشتها واتخاذ المواقف منها، حيث ينتقل الطفل الناشئ من الجنسين من مرحلة الأخلاق الإجرائية التي تندرج في إطار المسموح والممنوع، الثواب والعقاب، إلى مرحلة بروز مفهوم الصواب والخطأ بمعزل عن القضايا والتفاعلات الفردية، وتتطور تلك المفاهيم مع تطور النمو الذهني والأخلاقي للشباب ويتطور معها مفاهيم وقضايا القيم والحقوق الأساسية وكيفية مراعاتها، بجانب المفاهيم المتعلقة بالأعراف والتقاليد الاجتماعية والامتثال لها أو الصراع معها. [3] مثل احترام حقوق الإنسان باعتبارها الأساس الناظم للعلاقات والممارسات السياسية والاجتماعية، أو التعارض بين الأعراف والقوانين وبين المبادئ العليا: العدالة، حقوق الإنسان، المرأة والطفل وذي الإعاقة، المساواة بين الجنسين والأعراف والكرامة الإنسانية، إنها بالأحرى مسيرة كبرى يحدث فيها التحول من الانتماء التقليدي والتبعية بين للمسلمات وبين البحث عن الاستقلال الذاتي باستكشاف التوجهات والخيارات.
مع ما سبق؛ تطرأ مسالة الحرية لدى الأبناء والنبات في عالم يحتاج اليه الشاب إلى الفطام النفسي من التبعية الفكرية والاتكالية على توجهات الأهل والمعلمين، كمرحلة في دخوله إلى عالم الرشد، وتوظيف قدراته العقلية الناشئة لإدارة حياته. حيث يرغب الكثير من الشباب تجاهل سؤال الأهل عن قضاياه خوفاً من أن يعني ذلك أنهم مازالوا ينظرون إليه بمثابة طفل عاجز عن توجيه ذاته. على العكس يجابه ويجادل ويكتشف الثغرات والتناقضات وأوجه القصور في تفكير الأهل كي يشعر بأنه قوي بدوره، وأنه لم يعد طفلاً.
يناطح الشاب/ة الأهل فكرياً وإرادةً كي يختبر قدراته الناشئة ويتأكد منها. فالشباب في هذه الأيام يريدون أن يكونوا (قباطنة) مراكب حياتهم الخاصة بفضل نمو قدراتهم الذهنية. يطلبون محبة الأهل وتقبلهم ومساندتهم مع تركهم يقودون مراكبهم. إنهم يتصرفون وكأنهم يبعدون الأهل بمجابهاتهم الفكرية لأنهم يتخيلون أن الأهل لا يعترفون بما يكفي بقدراتهم ومشاعر القوة الذاتية اللازمة لها، وبالتالي لا يماشون متطلباتهم في الاستقلالية والقرار. بينما يريد الأهل البقاء متمسكين بدفة توجيه مراكب أبنائهم لأنهم يخشون عليهم من الوقوع في المشكلات والعجز من توجيه الدفة. وهنا ينبغي إعادة التركيز على القاعدة الأساسية هي شعور الشباب بأنهم مؤهلين لإدارة حياتهم وأنهم يستحقون المعاملة كراشدين ويستمتعون بقدراتهم العقلية ويجربون القيام بالأدوار الراشدة في حياتهم، وليس أشد إيلاماً عليهم من التقليل من تفتح قدراتهم الذهنية ومحاولة السيطرة على أفكارهم ومشاعرهم. [4]
يتقدم النمو الاجتماعي على صعيد علاقات تطور الشباب عبر دخول عالم المدرسة، حيث يخضع الطفل ولأول مرة لقانون مؤسسي غير قانون الأسر، ويتعزز لديه التوجه نحو رفاق الدراسة واللعب والجيران وأندية النشاطات، بعد أن يكون قد رسخ بناء عالمه النفسي الداخلي في كنف الأسرة، ويبرز التباعد عن الأهل والتمايز عنهم بقدر اندماج الناشئ في مرحلة ما قبل المراهقة ومرحلة الشباب وأوائلها مع الأصحاب والرفاق. وهو ما قد يقاومه الأهل التملكيون بشدة، حيث يرفضون أن يحققوا (الفطام النفسي) وقد يشعر الأهل أنهم قد أصبحوا مستغنى عنهم إلى حد ما.
من جهة أخرى تؤثر علاقات الصداقة على تطور اتجاهات الشباب في تلك المرحلة، حيث تشكل جسر العبور إلى العالم الاجتماعي المفتوح، وتوفر الفرص للنمو الاجتماعي، أي التحول من علاقات الطفل ، إلى علاقات المشاركة بين الأصدقاء، حيث يبدأ الشباب في تلك المراحل المدرسية التدريب على المهارات الاجتماعية ولعب أدوار رعائية بالنسبة للأصدقاء الأصغر وأدوار تابعة بالنسبة للأكبر سناً، إضافة إلى العلاقات الندية، كما يتعلم الشباب في تلك المرحلة مع جماعة الأصدقاء التعادلية في الأدوار ويكتسبون مفهوم الأخذ والعطاء والربح والخسارة والتعال ومهارات الاتصال والتفاوض. وتشكل الجماعة أو شلة الأصدقاء بيئة هامة (للنمذجة)، وهي طريقة للتعلم عبر المحاكاة كما صاغها عالم النفس المعرفي الاجتماعي (ألبرت باندورا) حيث يكتسب الشباب في مراحل الطفولة وفق تلك النظرية بعض الصفات والخصائص السلوكية المرغوبة من البالغين والأصدقاء التميزين في هذا المجال او ذاك من مجالات التعامل مع الحياة. [5]
وتعتبر كذلك جماعة الشلة أو الأصدقاء هي فرصة مهمة كذلك لتعلم الأدوار القيادية والحصول على العبية والجاذبية الاجتماعية. ويتعلم الشباب في تلك المرحلة من أصدقائهم مفهوم القانون الذي يحكم السلوك والعلاقات الاجتماعية، ويشكل الانتماء إلى ثقافة الشباب من خلال جماعات الأصدقاء وسيلة مهمة للتفرد والتميز عن عالم الكبار وتعزيز الاستقلالية عنهم، وبلورة الهوية الشخصية.
ولعل أبرز ما يميز ثقافة الشباب راهناً الانخراط في التعامل مع تقنيات الاتصال والإعلام الاجتماعي، والشراكة في الاهتمامات النفة والخروج وأماكن السهر، يتمسك الشباب بتلك الأنماط السلوكية كونها تعد الوسائل التي تعزز الكفاءة الاجتماعية لهم، في بناء عوالمهم المستقلة، وتعلم اكتساب مهارات الانتماء للمؤسسات والتنظيمات الاجتماعية المختلفة والتمرس بأنشطتها والتدرب على أدوارها للدخول إلى الحياة الراشدة.
دور المناهج في تكوين مواقف واتجاهات الشباب نحو الحركات/الحراكات الاجتماعية
(كأنكم كنتم الأساتذة وكأني كنت أنا التلميذ. خليل السكاكيني)
تتجلى لدى الشباب في بداية مرحلة الشباب نضج النمو الاجتماعي في الممارسة والتطبيق، والقدرة على الارتباط والتعلق والالتزام، وهنا يتم التحول في مجال الاهتمام بالحياة الاجتماعية من التركيز على اكتساب المهارات الاجتماعية إلى التركيز على ممارستها، وصولاً إلى تحقيق نتائج اجتماعية مرغوبة. ذلك أن امتلاك المهارات الاجتماعية في محيط الأهل والشلة والمدرسة لا يضمن بالضرورة حسن توظيفها، لخدمة المصالح الذاتية ومصالح الآخرين. إنها مهارة ممارسة الحياة التوافقية مع الآخرين والتكيف النشط، أي قبول ما يجب قبوله وتغيير ما يجب تغييره، والتعامل مع ما لا يمكن التدخل فيه.
تشكل مناهج التعليم الرسمي سواء المدرسي أو الجامعي، نتاج التعلم الذي يتعرض له الطلبة عبر سلسلة من الخبرات المخطط لها في المدرسة أو الجامعة، وفي فلسفتها تبنى على أسس نفسية، معرفية، اجتماعية، سياسية. وهي تشكل كذلك المحور المركزي في الحياة خلال الطفولة والمراهقة وأوائل سن الشباب.
وفي الواقع التعليمي الفلسطيني، يبرز الصراع بين اتجاهات المناهج الفلسطينية حول فرط التركيز على أنماط التلقين والتحصيل المعرفي، ومحاصرة الطلبة وتقييد حيوتهم كي لا يكرسوا أنفسهم لجهة الاكتشاف والتعبير والتفتح والرغبة في أخذ النصيب من مآثر الحياة وإثارتها ومغامراتها وطلعاتها، وفي مرحلة الجامعة يبرز كذلك الصراع نحو التخصص العلمي والمهني، بينما يريد الشباب تقرير خياراتهم التخصصية، بما يتماشى مع تطلعاتهم وميولهم الذاتية وبين توجهات الأهل ودورهم في تحديد تلك الخيارات ووضع سقوف لها.
وبالرغم من تطور الحركات والحراكات والثورات الاجتماعية على الصعيد العربي، لا يزال نظام التعليم العربي والفلسطيني ينتمي إلى نظام التعليم البنكي الذي يتولى إيداع المعلومات في عقول الطلبة ويقوم باستخراجها عند الامتحان. بمعنى فصل التعليم عن قضايا وحاجة المجتمع للتطور وجعله خاضعًا للسلطات السياسية والاجتماعية والدينية التي تلتقي عند هدف السيطرة، وبهذا لم تتطور المناهج الفلسطينية على نحو بارز يواكب التطورات والتغييرات الاجتماعية الحاصلة في المجتمع. بل أن بعض الاتجاهات تذهب حد وصف المناهج على أنها تساعد في تعزيز النفوذ والسيطرة على المجتمع وبقاء نظام الحكم على حاله، مع عدم استبعاد توظيفه ضد الاحتلال أحيانًا وضمن السقوف السياسية المتبدلة. [6]
ولم يكن من باب الصدفة التوافق على الكتب المدرسية بين سلطتي فتح وحماس السياسيتين والمؤسسة الدينية والعشائر والحمائل والعائلات كقاعدة اجتماعية للسلطتين. ولم يكن من باب الصدفة أن جهاز التربية والتعليم الرسمي يتحكم به قوى محافظة فتحاوية تنتمي إلى المدرسة الدينية المتزمتة، وتتنافس مع الإسلام السياسي على التزمت والانغلاق، وقد تركت بصماتها على الكتب المدرسية وسياسة التعليم، وكل هذا يتم بنوع بتأييد براغماتي الطابع من سلطة وقيادة فتح التي ينتمي أكثرها للعلمانية، تلك الازدواجية يقف خلفها التنافس مع الإسلام السياسي على النفوذ، ولكن من داخل أيديولوجيته، والتعايش والتأقلم مع التحولات الرجعية داخل المجتمع.[7]
يعتمد بقاء مشاكل التعليم واستفحالها من جهة، أو التصدي لحلها وتجاوزها من جهة أخرى، على البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية السائدة والسلطة المنبثقة عنها. وإذا كان للتعليم دورا في إحداث تغيير مجتمعي يساهم في قيادته الشباب، فإن هذه العملية ستكون محصلة صراع وتنافس القوى والنخب على النفوذ. إن وضع التعليم في خدمة السيطرة يلخص المشكلة في اتجاهات الشباب وأدوارهم في التغيير الاجتماعي، ويفسر التباين في الاستجابات. فالبنى والنخب التي لها مصلحة في تطوير المجتمع، تكون معنية بإطلاق مبادرات تطوير التعليم، وبالسعي للتغلب على العقبات والاعتراضات التي تنشأ في سياق هذه العملية. والبنى التي لا ترى غير السيطرة والتحكم بالمجتمع فإنها تكبح كل محاولة لإطلاق طاقات وحريات الشباب وكافة فئات المجتمع عبر أحد أهم الروافع الممثلة بالتعليم، كما أن الفكر والثقافة السائدين لهما تأثيرهما الملموس على السياسات التعليمية والمناهج المقرة.[8]
ففي مرحلة صعود الثورة الفلسطينية ساد الطابع العلماني بتأثير المستوى الثقافي الذي كان حاضرا ومؤثرا، وانتشر في تلك المرحلة الفكر التقدمي، وطرحت الدولة الديمقراطية العلمانية، وجاءت وثيقة إعلان الاستقلال لتعبر عن ذلك التقدم. وفي مرحلة انتشار ثقافة الإسلام السياسي المحافظ، جرى تعريف فلسطين في المناهج كدولة عربية إسلامية وترك الفكر التعصبي بصماته المحافظة على العملية التعليمية برمتها.[9]
ثمة علاقة بين الفكر والثقافة السائدين والسياسات التعليمية والقوى المسيطرة. وانعكاساتها على أدوار الشباب وأنماط مشاركتهم الاجتماعية، ففي ظل سيادة الفكر المحافظ وترهل الفكر المتنور التقدمي، تغلغلت القوى المحافظة في التعليم وتحولت المدارس ومعها قوة التغيير الافتراضية) الطلبة في مختلف المراحل (إلى بنية تحتية للقوى المحافظة والمتعصبة التي تركت بصماتها القوية على الأجيال الجديدة بصيغة تعصب وانغلاق.[10]
إن المستوى الثقافي والأكاديمي المتنور والمعني بالتغيير راهنا هو الأكثر حرصا على تعزيز ثقافة التنوير والانفتاح والعقلانية عبر التعليم. إن نظام التعليم المعمول به، يعكس مصالح النخب السياسية في الحكم أو في المعارضة، حيث يستخدم نظام التعليم في السيطرة على المجتمع وبقاء التنظيم الحاكم إلى ما لا نهاية، وفي تكريس نظام غير ديمقراطي، أو في تعزيز السيطرة على المجتمع من موقع المعارضة المنغلقة وغير الديمقراطية. يتجلى الفرق الجوهري في استخدام نظام التعليم، استخداما للتحرر الوطني والاجتماعي ولتعزيز الديمقراطية والانفتاح والتطور أو العكس، ضمن مستوى أكثر أوأقل سوءا.[11]
يجوز القول إنه بالإمكان التعرف على النظام السياسي والقوى السياسية والحركات والحراكات الاجتماعية التي يشارك فيها أو يقودها الشباب فيما إذا كانت ديمقراطية ومتنورة وعقلانية وتقدمية من خلال رؤيتها للتغيير وموقفها من نصف المجتمع من النساء والبنات، أم هي امتداد لحالة التبعية وإبقاء التخلف والانغلاق والهيمنة من أجل إدامة السيطرة للنخب السياسية والاقتصادية القائمة.
من البحث في إشكالية التنشئة إلى البحث في إفرازاتها على أدوار الشباب في الحركات/الحراكات الاجتماعية
لطالما قدمنا فيما سبق أن التنشئة تلعب دوراً محورياً في تشكل مواقف وعقائد واتجاهات الشباب في العمل السياسي والاجتماعي، يبقى السؤال كيف تفرز التنشئة أنماط الشباب ومستويات وطرق انخراطهم في الحراكات الاجتماعية، وبأي هويات اجتماعية تتجلى أدوارهم في العمل الاجتماعي العام.
بدايةً يمكن تتبع وتحليل مجموعة سمات للحراكات، تختلف عن الحركات. أولاها، أنه على الرغم من أن جزءاً من ظهور الحراكات جاء تعبيراً عن شعور بالفراغ السياسي (عدم وجود عمل مؤطر جاذب) وعدم قدرة البنى السياسية الراهنة على القيام بأعباء المشروع الوطني، فإنّ الحراكات جاءت تتحرك لأجل هدف محدد ومحدود، آني يبرز في لحظة معينة، مع توقع أنّ يؤدي تحقيق هذا الهدف (إنهاء الانقسام مثلاً) إلى تغيير في مجمل مكونات المشهد السياسي، وبالتالي سيحدث تغيراً إيجابياً، تتحدد معالمه لاحقاً، بعكس الحركات والأطر التي عملت في القرن العشرين، مع تصور واضح -إلى حد كبير- للمستقبل ومتطلباته، بل مع تصورات لكيفية تكامل العمل الفلسطيني مع سياقات عربية وعالمية أوسع.[12]
ومنذ مطلع القرن العشرين وحتى نهاية الحرب الباردة، والحراكات التي ظهرت بالتوازي مع العولمة ومرحلة أوسلو ثم الربيع العربي، بعد العام 2011. في الحالة الأولى، كانت الأطر الشبابية، إما نواة يدرك مؤسسوها سلفاً أنها ستتحول إلى حركات أو أحزاب، لديها شعارات أو برامج أو رؤى نحو مجمل القضايا الوطنية، أو على الأقل مستعدة للتفاعل مع طائفة واسعة من القضايا، ويعد الاتصال الشخصي هو أداة التواصل الأساسية في هذه الأطر، مع نظام عضوية محدد، وغالباً ما يكون تأسيس البناء التنظيمي وشبكة الأعضاء مرحلة سابقة، وهذا ما كان عليه الأمر في الخمسينيات والستينيات بشكل خاص. وإذا لم تكن هذه الأطر نواة لأحزاب وحركات، فهي، غالباً، ذراع أو منظمة فرعية من حزب أو فصيل أكبر، وهذا ما كان عليه الوضع من السبعينيات وحتى التسعينيات، مع العمل على أطر وطنية جامعة للشباب، مثل الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين.
جاءت حراكات العولمة والربيع العربي مختلفة، من حيث، أولاً، أنها تعتمد على الرفض للواقع أكثر من تقديمها تصوراً محدداً لما تريده، ولكيفية الوصول إلى واقع جديد. وثانياً، أنها تعتمد على الفعل المباشر؛ أي النزول إلى الشارع دون الكثير من التخطيط لخطة عمل متكاملة، وقد تحدد أهدافها وهي في الميدان، بناءً على استقراء مزاج الشارع، ومدى قوته وبناء على استقراء مواقف القوى المختلفة. وغالباً ما يكون الهدف جزئياً قد يؤدي إلى تغيير في طبيعة العملية السياسية، وطبيعة القوى المسيطرة، والعلاقات بينها. وثالثاً، أنها تعلن براءتها من الفصائل والأحزاب والقوى السياسية التقليدية المنظمة، والسبب في ذلك الاستياء من أداء هذه القوى، وبخاصة من حيث الضعف وعدم الرضى الشعبي عنها، ورفض هذه القوى لتبني روح الشباب ومطالبهم، ولأن هذه القوى منقسمة، وتدخل في صراعات جانبية بعيدة عن القضايا الأساسية (ولأنها باتت تمثل سلطة ولو محدودة السيادة)، ولأن هذه الفصائل لا تمتلك برنامج عمل أو رؤية واضحة مقنعة. يضاف إلى ذلك، أنّه بنهاية الحرب الباردة، وانتهاء الاستقطاب بين الفكرين الرأسمالي والاشتراكي، تراجعت كثيراً جاذبية العقائد والأيديولوجيا الشاملة.[13]
يضاف إلى كل ما سبق، أن سهولة الوصول للإعلام المجتمعي، أضعف الحاجة للتمويل، وللإمكانات المادية والخبرات والمؤسسات، التي كانت ضرورية لأي عمل جماهيري، والتي كانت الأحزاب والقوى المنظمة هي من يمتلكها ويقدمها، فأصبح يمكن لأي مجموعة شبابية أن تصنع إعلامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا ما جرى قصر النظر على الحراكات الشبابية الفلسطينية، يمكن الإشارة ، إلى أن الحراكات في الأغلب فشلت في تحقيق أهدافها المحددة، وكثيراً ما كان أعضاء حراك يتسربون إلى حراك آخر، أو يبتعدون عن المجال العام، ويأتي حراك جديد في مناسبة أخرى يتبنى هدفاً ما، أو كانت الحراكات تنتهي لشعور بالفشل والكارثة، ولوهلة، كان مصطلح التشبيك في إشارة إلى عملية ضرورة الربط بين المجموعات الشبابية المختلفة، باعتبار ذلك هو الحل، لكن الحقيقة التي تبدت مع الوقت، أنّ هناك مشكلة داخل المجموعات ذاتها، وأن المجموعات ذاتها لا تملك مقومات الاستمرار والتطور، وبالتالي تفقد الشبكات أهميتها.
أحد أهم أسباب عدم الاستمرار يكمن في صفة الشبابية ذاتها، فالشباب هو، من زاوية محددة، مرحلة عمرية مؤقتة، وكثيراً ما يرتبط النشاط العام لدى الشباب بمرحلة تعليمهم الجامعي، حيث الجامعات والمعاهد فضاء عام للقاء والتنظيم والتحرك، وبتقدم السن والانتقال إلى أدوار ومكانات اجتماعية جديدة، لا تعود ظروف استمرار الشباب في النشاط متاحة، وبخاصة بغياب الأحزاب، وغياب الحياة النقابية المتجددة، كما هو الواقع الفلسطيني. فحتى في الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين، لا يوجد تجديد للقيادات عبر الانتخابات، ويمثل الاتحاد في المجلس الوطني أشخاص في الخمسينيات من أعمارهم. من الأسباب الأخرى للتعثر وعدم القدرة على التقدم، ومن ثم التفكك، اعتماد الحراكات الجديدة فكرة عدم وجود قيادة مركزية، والاعتماد على التوافق. والنفور من القيادة جزء منه يعود إلى الرغبة في تفادي صراع القوة، وعمليات تقديس الفرد، أو التكالب على الموقع، وهي جميعها ظواهر برزت في الحركة السياسية الفلسطينية، فنادراً ما غاب قائد أو أمين عام فصيل لسبب غير الوفاة، أو التراجع الكبير في الحالة الصحية، بل إن كثيراً من الاتحادات والنقابات والجمعيات الخيرية لا تغير أيضاً قياداتها. يضاف إلى هذا النفور، جاذبية وسهولة وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت آلية نقاش وتواصل أغرت الكثيرين بأنّه لا حاجة إلى قيادة مركزية. [14]
وفي أوقات الأزمات واللحظات الحرجة يصعب الاعتماد على قرار يتخذ عبر تشاور عدد كبير من الأشخاص، بعضهم قد يصبح جزءاً من الحراك في مرحلة متقدمة من ظهوره، وأن جعل القرارات غير ملزمة أمرٌ غير عملي، ويؤدي إلى انقسام وتشتت وتناقض في القرارات. ويرتبط بموضوع أثر الافتقار إلى القيادة على عملية صنع القرار، أثر الافتقار إلى التأطير والعقائد أو البرامج أو الرؤى السياسية. فصحيح أن بعض الفلسفات والأفكار، تتحول إلى نوع من الجمود الذي لا يواكب العصر، وإلى أيديولوجيا يراد مشاهدة الواقع عبرها، لدرجة إمكانية تحريف الواقع ورؤيته من الزاوية التي تجعل النظريات صحيحة، لا من حيث ماهية هذا الواقع حقاً، ولكن، أيضاً، عادة ما تتخذ القرارات والمواقف لتتلاءم مع أما بدون مرجعية سياسية وفكرية بين الأعضاء ومبادئ متفق عليها سلفاً، فيصعب تحديد أسس اتخاذ القرار. وبهذا يمكن القول إنه وفي في أغلب الحراكات الاجتماعية تفتقر إلى الأيديولوجيا والمرجعية السياسية له، ويغلب عليها طابع الرفض للواقع وليس كيفية تغييره، أي غياب نهج للتغيير، وأنها تفتقر إلى القيادة المركزية في غالبية أنشتطها بجانب نفورها من الفصائل والتنظيمات، فالنفور من تلك الفصائل والتنظيمات لا يلغي الحاجة إلى هيكلية تنظيمية، كما أنها تعاني من العضوية الفضفاضة حد الفوضى التي ينتج عنها تبعات سلبية.[15]
خلاصة:
- الأبناء والبنات ليسوا تكرار لنسخ طبق الأصل عن الوالدين بل هم كيانات تتصف بتجاوز الأصل في أغلب الأحيان، كما هو شأن التقدم في الحياة ذاتها، فالحياة العاطفية والاجتماعية للأبناء والبنات ليست نسخة طبق الأصل عن حياة والديهم ولا يجوز أن تكون كذلك. فالأبناء يكبرون في عالم مختلف إلى حد بعيد عن ماضي الوالدين، ومتطلبات التعامل مع هذا العالم المغاير وإيجاد المكانة فيه ومتطلبات النضج العاطفي يجب أن تراعي خصائصه وتحولاته.
- إن أثر مشاركة الشباب في الحركات الاجتماعية يمكن تتبع تشكلاتها في النظام التعليمي السائد، الذي يميز ضد النساء ويضعهن تحت الوصاية والسيطرة، ويتخذ اتجاهات سواء كانت خفية أو علنية تجاه التعصب الديني، والخضوع للنظام السياسي المسيطر، فالمناهج التعليمية بصورة عامة، سواء أكانت مدارس أم جامعات وغيرها، هي أمكنة تمارس فيها السلطتين السيادية والتأديبية.
- في المؤسسة الأكاديمية تمارَس السلطة التأديبية الخفية، وتؤثر في اتجاهات الشباب وأدوارهم في الحيز العام ، فمفهوم التأديب يشمل علاقات السيطرة الخفية والواضحة في الصف المدرسي أو الجامعي، كما تتجسد في المنهاج الدراسي والاختبارات التي تحوّل المعلومات إلى قيم رقمية يمكن أن تحسب وتقاس، وهو ما يعمل على إيجاد صورة جديدة لإعادة إنتاج دور الشباب في المجتمع (بتراتبيات سلّم التقييم الصفي مثلاً) كما لو أنها صورتهم الحقيقية وليست نتاج السلطة الخفية، بالإضافة إلى أن موقع الأستاذ في المؤسسة التربوية، يعمل على إعادة إنتاج السلطة السيادية، لأنه يمارس سلطة واضحة على الطلاب في الصف التعليمي ويفرض عليهم ما يسمح لهم وما يحظر عليهم.
- إن أيّ منهاج تحرري، عليه بالضرورة أن يهدم علاقات القوى وسلطويتها وتراتبيتها هذه ويعيد إنتاجها بطريقة تتلاشى فيها الفروق بين المعلّم والمتعلّم، لأن المؤسسة التربوية أكانت جامعة أم مدرسة، لها اشتراطاتها على مسيرة العملية التعليمية ونتاجها حتى في أكثر الجامعات التي تتجه نحو التعليم الحديث واحترام الطالب ورأيه، إذ يُشترط في المؤسسة الأكاديمية أن توضع علامات رقمية لتقييم أداء الطالب غير الرقمي، وتتجه في كثير من الأحيان إلى تسليع العملية التعليمية والاهتمام بالكمّ على حساب المضمون! وهذا ما يدفع أحياناً المعلمين إلى تلقين المعرفة تلقيناً دونما اهتمام بالمضمون ودونما سعي لتحرير ذهن المتعلمين ومساعدتهم على صناعة الثغرات النقدية في أذهانهم. وهذا ما انتبه إليه مبكراً باولو فريري الذي دعا إلى اعتماد نهج التعليم الحواري ومشاركة المتعلم في العملية التعليمية بدلاً من التعليم البنكي أو اللاحواري، الذي يتعامل مع المتعلّم كوحدة صمّاء وسلبية وفاقدة الفاعلية، إذ ركز فريري على أهمية تحقق الفاعلية بممارسة المتعلمين التجربة النضالية والتحررية بدلاً من تعلمها فحسب وهو ما يؤدي إلى شق الطريق أمام تحرير الطلبة لذواتهم، ويهيئهم لتغيير الواقع والمشاركة في إعادة تشكيله ، بما يحقق بدوره عملية التحرير الجماعي لأفراد المجتمع.[16]
[1] https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3786أنظر موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
[2] أنظر إريك إريكسون ونظريته: النمو النفسي – اجتماعيا
[3] أنظر نظرية كولبرج في نمو التفكير الأخلاقي
[4] حجازي، مصطفى، المراهقة تلك الأعوام المثيرة. ورشة الموارد العربية.2013
https://mawared.org/sites/default/files/book_al_morahaka.pdf
[5] حجاج،حسن. دراسة مقارنة، نظريات التعلم. عالم المعرفة
https://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/kutub/TAALOM.pdf
[6] عبد الحميد، مهند. المناهج المدرسية بين استثمار الرأسمال البشري وهدره. مؤسسة روزا لكسمبورغ.2019
[7] المرجع السابق
[8] المرجع السابق
[9] المرجع السابق
[10] المرجع السابق
[11] المرجع السابق
[12] عزم، أحمد. الشباب الفلسطيني من الحركة إلى الحراك(1908-2018)، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية. 2019
https://www.masarat.ps/files/azembookyouth.pdf
[13] المرجع السابق
[14] المرجع السابق
[15] المرجع
[16] الحاج، قسم. ماذا يعني التعلم التحرري في مجتمع فلسطيني مستعمر. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 2021